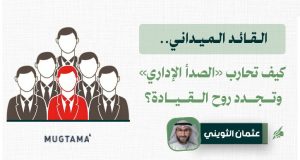وسط عالم مفتوح بلا حدود، متغول بلا قيود، متوحش بلا أخلاق، تمثل سلطة إنتاج المعرفة فيه رأسماله الذي يجب أن يمتد ويشتد، حتى غدت إحصاءات الدلالة المرعبة لهذا التدفق، تكاد تسير في اتجاه واحد.
فمن بين 118 مليار تغريدة من عام 2009 إلى عام 2019م، أظهرت أن 80% منها، كان بلغات مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية واليابانية؛ ما يدل على هيمنة المحتوى الغربي على المنصات الرقمية، إضافة إلى الدلالات المخيفة السابقة، لمعدلات القراءة التي لا تتجاوز 0.08% في بعض الدول العربية والإسلامية، وكذلك الميزانيات المرصودة للثقافة والبحث العلمي التي لا تكاد تصل في بعض الدول إلى 0.02%؛ ما يشير إلى مستقبل معلوماتي مفزع إلى أبعد الحدود.
ولعل أخطر منتجاته واقعياً اتساع الفراغ بين الأجيال، وعمق الهوة الرقمية التي سيصعب ردمها، إن لم يكن مستحيلاً فيما بعد.
ومنذ طرْح أحادية النظام العالمي الجديد، أوائل التسعينيات من القرن الماضي، والميل الواضح إلى «أمركة» العالم، ضمن الرؤى والفلسفات السابقة والمواكبة لهذا المسار الأحادي؛ من صدام الحضارات، وصراع الثقافات، وأدلجة رؤى برنارد لويس، وصمويل هانتجتون، وفرانسيس فوكوياما.. وغيرهم، ممن أصّلوا وفصّلوا لمسألة قطار التاريخ، والسعي إلى اعتماد القوة، والقوة المفرطة، في قولبة الكوكب، وبسط مسودات إنفاذ السلام، والحريات، والحقوق، عبر اعتماد ذراع القوة، وإلغاء العمل الخاص بذراع المقاومة، في أي قضية، وأي مكان من العالم.
ومع لملمة روسيا لأوراقها من جديد، وتغولها على كل عمليات ومبادرات النهوض الإسلامي لدول الكومنولث السوفييتي الإسلامية، ومع قيام الصين كمحور عالمي قادم، بنفس العمل تقريباً مع مسلمي الإيغور وإقليم تركستان الشرقية، ومحاولة كل دول أوروبا تقريباً بإنتاج و«أوربة» إسلام جديد، منزوع الدسم، ومع تخبط التوابع العربية والإسلامية في نفس المسير والمصير؛ برزت على السطح -بعدما تشعبت في الطول والعرض والعمق- إشكالية عميقة تتعلق بكيفية فهم واستيعاب المفاهيم الإسلامية الأصيلة، ضمن هذا السياق العالمي المتحفز المستطير، الذي تهيمن عليه أنساق معرفية مادية، وعلمانية حداثية، وما بعد حداثية، تؤثر على طريقة إنتاج وتداول المعرفة، واستحقاقاتها في ميادين التربية، والتعليم، والتكوين، والتثقيف والبحث، والدرس، والسياسة، والأدب، والدين والأخلاق.
هذه الموجات المتسارعة، من استفراد هذا الجناح «المتأمرك» من العالم بالآخرين، جعله يفرض عليهم فرضاً جبرياً، مفاده «من ليس معنا، فهو ضدنا»!
بل ودفعه ذلك الغرور الحضاري إلى أن يخوض 7 حروب كبرى بالمنطقة لحسابه، على أراضي الغير من ضحاياه، ومحل أطماعه بالمنطقة؛ ما أسفر عن تبديد ثروات وكنوز قلب العالم، وارتداد شعوبها 40 عاماً إلى الخلف، وانشعابها أمماً وأقواماً شتى، وإذهاب ريحها، وتفكيك بناها، وتحطم قواها، ومصادمة كل تطلعاتها، إلا ما يصب منها في حقائبه، وينضوي تحت رغائبه.
من هذه التحوّلات المتسارعة التي يقودها النظام العالمي المهيمن القائم على العولمة؛ هيمنته على المعلومة والتقنيات الرقمية المنتجة لها، وفرض أنظمة التفكير المادي، ودهس كل ما يحول دون تحقيق هذا النهج المتوحش من الاقتصاد، والإدارة والسياسة والثقافة والفنون والآداب.
تغول معرفي
هذا الواقع أنتج تغوّلاً معرفياً جارفاً، حيث فرضت منظومات فكرية وثقافية تصوّراتها ومفاهيمها كمعايير كونية؛ ما يضع المفاهيم الإسلامية أمام تحدّيات جدّية، من حيث التفاعل أو المقاومة، أو التوافق أو المصادمة.
هذا التغوّل المعرفي أدى إلى سيطرة منظومة معرفية معينة على باقي المنظومات، وفرض مرجعيتها ومعاييرها في تفسير الإنسان والكون على باقي المرجعيات، وهيمنة النموذج الغربي الحداثي وما بعد الحداثي على الحقول العلمية، والأنساق الفكرية، والمناهج العلمية، والنظرة للوجود والمعنى، والحياة والإنسان.
كل ذلك على حساب المفاهيم الإسلامية، ذات البنية الخاصة والنظام المرجعي المغاير، ذلك أن المفاهيم الإسلامية نابعة من الوحيين؛ القرآن والسُّنة، إلى جانب تميّزها ببنية تكاملية، تشمل الروحي، والأخلاقي، والمعرفي، والسلوكي؛ كالتوحيد، والأمة، واللغة العربية، والشورى، والتراث، والعدل، الرحمة، والخلق، والاستخلاف، والموت والقيامة، والجنة والنار.
وكلها مفاهيم دلالية عميقة ومتجذرة، ولا يمكن اختزالها في مفاهيم حداثية مقابلة، أو في الجامعة، التعاطي معها بعيداً عن مصادر استمدادها العالية، من القرآن والسُّنة والسيرة النبوية والفقه والوعي والأصول.
أدى ذلك التغوّل السياسي، والاستفراد القطبي، إلى ما يشبه الانتهاك المعرفي للمفاهيم الإسلامية، خاصة مع وعي الغرب القديم، بمحصوله الاستعماري للمنطقة جميعاً، ومهاراته الظاهرة والخفية، في تأسيس وتسييس الجماعات الوظيفية لحماية ورعاية المصالح؛ مما أدى إلى:
– خلخلة المرجعية، بالشغب الدائم على المرجعية الإسلامية الصافية والوافية والكافية.
– اعتماد سياسة التفكيك، وتضارب المرجعيات، وتأجيج الصراع السُّني الشيعي.
– إشعال الصراعات العرقية، والإثنية، بالمنطقة.
– إثارة مشكلات وحروب الحدود، واللعب على الدعم الدولي والتدخل الخارجي بشأنها.
– الشغب العمدي على التراث، والانطلاق منه إلى المطلق، وشغل الفضاء الثقافي، بل وتوريطه في هذه الهزات الارتدادية، المتتابعة والمنظمة والمحمية.
– تبديل المفاهيم، خاصة ما يخص المرجعية من الوحيين، والمرأة، والتراث، والهوية، واللغة، والحضارة.
عوامل للمقاومة
وللخروج من الأسر، ولكسر ذلك الطوق، يجب العمل على ما يلي:
– إعادة الوعي العام والخاص إلى مركز الدائرة، من حيث الذات والهوية.
– حماية المرجعية، بعد التوافق عليها، والاتفاق على اعتبارها مشروعية عليا للأفراد والمجتمعات.
– إعادة بناء الوعي، واعتماد مشاريع الانعتاق الحضاري، ورفع درجة وجوبيتها إلى الصدارة من سلم الأولويات.
– تحرير المفاهيم الإسلامية من ربقة الأسر الغربي.
– العمل المؤسسي والمجتمعي على إعادة إنتاج المعرفة، واستصلاح حقولها، بناء على منظومة إسلامية واعية، تنتج نظاماً حضارياً إسلامياً أصيلاً، يسعى الرواد مع الأمة إلى تحقيقه، ولا ينوبون عنها فيه.
فالقضية الآن إنما هي فعل لا رد فعل، وشهودٌ لا مشاهدة، وتدافع لا تراجع، فالكون لا يعرف السكون، والطبيعة لا تعرف الفراغ، ومن لا يتقدم حتماً سيتقادم.
كلمات دلاليه
د. محمود خليل
 الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة
الشبكة الجزائرية نت البوابة الجزائرية للاعلام والثقافة